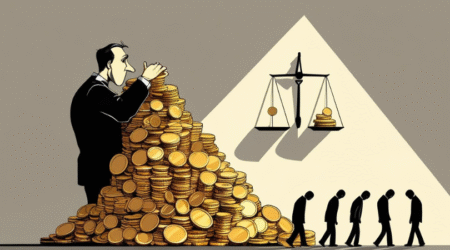أغسطس
القبض في العقود وأثره في الضمان وصحة التصرف في الشريعة الإسلامية

تمهيد:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ وبعد..
فإن القبض في العقود الشرعية من المسائل الجوهرية التي أولتها الشريعة الإسلامية عناية كبيرة، لما له من أثر مباشر في تحديد الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين. فهو ليس مجرد إجراء مادي، بل مرحلة فاصلة بين الالتزام النظري بالعقد وبين تفعيل آثاره الواقعية، حيث يترتب عليه انتقال الضمان وصحة التصرف. وفهم ضوابط القبض ومعاييره يُعَدّ من الأركان الأساسية للتعاملات المالية المعاصرة، خاصة في ظل تطور وسائل الدفع والتسليم.
أولًا: تعريف القبض وأهميته
القبض في اللغة هو: الأخذ والتمكّن من الشيء، وفي الاصطلاح الفقهي هو: حيازة المبيع أو المال محل العقد حيازةً تُمكِّن من الانتفاع والتصرف فيه تصرفًا كاملًا، سواء كانت هذه الحيازة حقيقية أو حكمية.
ويعد القبض من أهم المراحل في تنفيذ العقود، إذ يفصل بين مجرد الالتزام العقدي وبين التمكّن الفعلي من المال أو المبيع. وهو ليس إجراء شكليًا فقط، بل يترتب عليه آثار شرعية كبيرة، أهمها انتقال الضمان، وصحة التصرف، وتمام ملكية المنفعة.
ثانيًا: أثر القبض في انتقال الضمان:
الأصل أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد العقد بالصيغة الشرعية (الإيجاب والقبول)، إلا أن الضمان لا ينتقل إلا بالقبض. وهذا ما دلّ عليه قول النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) [رواه أحمد وأصحاب السنن]، أي أن الحق في الغلة والمنفعة يكون لمن يتحمل تبعة الهلاك أو النقص.
فإذا تم البيع وانتقلت الملكية نظريًا، ولكن المشتري لم يقبض المبيع بعد، فالهلاك قبل القبض يكون على البائع، إلا إذا كان هناك تعدٍّ أو تفريط من المشتري.
مثال ذلك: لو اشترى رجل سيارة ودفع ثمنها، لكنها بقيت في معرض البائع، ثم تعرضت لحريق قبل استلامها، فالخسارة على البائع لا على المشتري.
ثالثًا: أثر القبض في صحة التصرف بالمبيع
من الأحكام الثابتة في الشريعة أن المشتري لا يجوز له بيع السلعة أو نقل ملكيتها قبل أن يقبضها. وقد جاء في الحديث الشريف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يبيع الرجل طعامًا ابتاعه حتى يستوفيه) [رواه البخاري ومسلم]
وهذا النهي يشمل الطعام وغيره من السلع على الراجح، لأنه مبني على منع الغرر وضمان استقرار الحق قبل التصرف.
فلو باع المشتري السلعة قبل قبضها، فإنه يكون قد باع ما لا يملك حيازته الفعلية، مما قد يؤدي إلى نزاعات أو ضياع للحقوق.
رابعًا: أنواع القبض:
فرّق الفقهاء بين نوعين من القبض، مراعين طبيعة الأشياء وتطور وسائل التعامل:
القبض الحقيقي: وهو الحيازة المادية الفعلية للسلعة أو المال، مثل استلام النقود باليد، أو أخذ السيارة من المعرض، أو نقل البضاعة إلى مخازن المشتري.
القبض الحكمي: وهو التخلية بين المشتري والمبيع بحيث يتمكن من الانتفاع والتصرف فيه، دون حيازة مادية مباشرة، مثل تسليم مفاتيح المنزل أو وثائق السيارة، أو إيداع المبلغ في حسابه البنكي بحيث يكون تحت تصرفه.
وقد جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (لا تبع ما ليس عندك) [رواه أبو داود والترمذي]، وهو دليل على ضرورة تحقق القبض أو التمكّن قبل البيع.
خامسًا: الفرق بين المبيع المعيَّن والمبيع الموصوف:
المعيَّن: هو سلعة محددة بذاتها، لا تنطبق إلا على فرد واحد، كأن يقول البائع: “بعتك هذه السيارة ذات الرقم كذا”. هذا النوع يمكن أن يتحقق فيه القبض الحكمي.
الموصوف: هو سلعة تنطبق على عدة أفراد بمواصفات معينة، كقول البائع: “بعتك سيارة من هذا الطراز بلون أسود”. في هذه الحالة لا يُعتبر القبض حاصلًا إلا بعد التعيين والتسليم الفعلي.
والسبب في التفريق أن الموصوف في الذمة قد لا يتوفر فعليًا عند وقت العقد، وبالتالي لا يمكن للمشتري التصرف فيه أو ضمانه قبل تعيينه وقبضه.
سادسًا: الحكمة الشرعية من اشتراط القبض:
القبض في الشريعة يحقق مقاصد عظيمة، منها:
حماية الحقوق: بتحديد من يتحمل تبعة الهلاك في كل مرحلة.
منع الغرر والنزاع: لأن حيازة المبيع قبل التصرف تمنع وقوع الخلافات.
ضبط المعاملات: عبر ضمان أن كل من يبيع أو يشتري يتعامل في ما يملك حقًا حقيقيًا.
خاتمة
القبض في الفقه الإسلامي ليس مجرد انتقال مادي للسلع أو الأموال، بل هو ركن أساسي لضبط المعاملات، وحماية المتعاقدين، وتحقيق العدالة الاقتصادية. ومن خلال التفريق بين القبض الحقيقي والحكمي، وبين المعين والموصوف، راعت الشريعة واقع التعاملات، وقدمت إطارًا مرنًا يتسع لمستجدات الحياة الاقتصادية دون الإخلال بالمبادئ الأساسية.